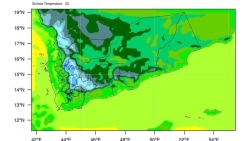مترجمون عرب يتحدثون عن مشاكل الترجمة من الأجنبية إلى العربية.. ويطرحون تصورات

[ مترجمون يتناقشون في محترف للترجمة - أرشيف ]
إذا سألت قارئاً عربياً عن كتب حفرت في ذاكرته، سيمرُّ على أعمال من أمهات الأدب العربي، بدءاً من معلقات الجاهلية وديوان المتنبي وصولاً إلى روايات نجيب محفوظ وأشعار محمود درويش. ولكن هل تتخيّل أنّه قد يتوقف عندها؟ الجواب البديهي كلا. فالمكتبة العربية لا تُبنى من دون ضم آداب العالم المترجمة إلى لغة الضاد. فالذائقة الروائية لا تكتمل من دون روايات دوستويفسكي وتولوستوي وفيكتور هيغو وسواهم. والذائقة الشعرية لا تنضج بلا قصائد هوميروس وأوفيد وبودلير وبابلو نيرودا وسواهم. والقراءة المسرحية لا تكتمل بعيداً من أعمال شكسبير ولوركا وصموئيل بيكيت.
أدباء كثيرون من العالم تركوا فينا تأثيراً كبيراً، فجعلوا حياتنا أكثر عُمقاً وأقلّ عُقماً. أضاءوا نوراً في دواخلنا ومنحوا الإنسانية إشراقتها. لكنّ إبداعهم ما كان يُمكن أن يصل إلينا من دون رُسُل الكلمة. المترجمون ليسوا جزءاً من حكاية الأدب. بل هم أصل الحكاية، وإن كان كثيرون يجهلون- أو يتجاهلون- دورهم في نشر الفكر المتنوّر وإرساء معالمه أينما كان.
وعلى أهميّة فعل الترجمة في مدّ جسور التواصل بين الحضارات المتباعدة، تبقى الترجمة في عالمنا العربي عملاً جاحداً هذا العمل الشاق، وهو أساساً نقلٌ مزدوج ذو اتجاهين، من اللغة (الأجنبية) إلى اللغة الثانية (العربية)، لا يعيد إلى صاحبه في كثير من الأحيان حقّه المادي أو المعنوي. اسمه يبقى غالباً مخفياً وراء اسم الكاتب، والبدل المادي مقابل جهده يظلّ ضئيلاً. هذا الواقع كان يعانيه كثيرون من المترجمين، ولكن هل مازالت معاناة المترجم قائمة في ظلّ وجود دور نشر ذات تمويل عربي ضخم؟ وهل أسهمت الجوائز في تحسين وضع المترجم وتحفيزه؟ وهل صحيح أنّ الترجمة مهنة شاقة وناكرة للجميل كما نسمع؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها في ما يخصّ واقع الترجمة من العربية وإليها، التقينا عدداً من أبرز المترجمين الحاليين على الساحة الثقافية العربية.
المترجمون الذين يساهمون في هذا التحقيق هم: صالح علماني (مترجم عن الإسبانية)، سعد البازعي (عن الإنجليزية)، خالد الجبيلي (الإنجليزية)، سمير جريس (الألمانية)، ماري طوق (الفرنسية)، معاوية عبد المجيد (الإيطالية).
- سعد البازعي: الترجمة ضرب من التأليف
سعد البازعي هو أكاديمي وكاتب ومترجم سعودي، لكنه لا يباعد كثيراً بين الكتابة والترجمة، فيقول في هذا الصدد: "نظرتي إلى الترجمة لا تكاد تختلف عن نظرتي إلى أي عمل ثقافي أقوم به ومن ذلك التأليف، ذلك أن الترجمة في نهاية المطاف، في تصوري، ضرب من التأليف. هكذا يفترض أو هكذا أنظر للأمر". أمّا عن اختيار النص المترجم فيجيب البازعي أنه يختاره على أساس الموضوع الذي يراه المترجم جديراً بأن يقرأ وأن ينشر، ويضيف: "أحياناً، قد انتقي موضوعاً كان يمكن أن أشتغل عليه لو سمحت لي الفرصة". هكذا تغدو الترجمة كأنها فعل تبنٍّ لنص أو عمل يؤمن المترجم بأهميته وضرورة أن "يُقال" بلغة أخرى. فالنص المُترجم، بالنسبة إلى البازعي، يُعبِّر عن رؤية المترجم مثلما عبّر أولاً عن رؤية المؤلف. ويُضيف قائلاً: "صحيح أن علاقة المؤلف بالنص ليست مطابقة لعلاقة المترجم لكنها تحمل نوعاً من التماهي الضروري مع النص، أولاً بغية إنتاج ترجمة ناجحة وثانياً لكي لا يكون المترجم مجرد ناقل لما لا يراه مهماً. أقول هذا مع أنّ تاريخ الترجمة مليء بالترجمات التي أنجزت على أساس من المسافة بين النص ومترجمه، كما في حالة التكليف المهني. هذه العلاقة الحميمة بين المترجم والنص الذي يختار نقله هي ما تحتاجه الثقافة العربية، تماماً كما تحتاجه أي ثقافة أخرى، وكما سبق أن احتاجته في عصر الترجمة الذهبي أيام المأمون. ولكنها لا تكفي بطبيعة الحال لنقلنا إلى عصر ذهبي للترجمة".
لكنّ البازعي يؤكّد أنّ تحقيق ذلك يحتاج إلى مزيد من الدعم، والدعم هنا ليس مادياً فحسب، من خلال الجوائز والمكافآت المادية - على أهميتها الشديدة - وإنما أيضاً إلى عمل إستراتيجي منظم". ويوضح رأيه هذا بالقول: "الترجمة بحاجة إلى مزيد من العمل المؤسسي المنطلق بناء على معايير وخطط تنظر للاحتياج الجماعي وليس الفردي فقط. لكنّ المترجم العربي يجد اليوم بعضاً من ذلك في مشاريع ترجمية قامت هنا وهناك (في مصر والإمارات والكويت ولبنان وغيرها). ومع ذلك، فإن الحاجة لا تزال ملحة للمزيد من العمل الذي يحول الترجمة إلى مشروع حضاري ويدعم المترجمين برفع قدرهم وتعزيز أهمية ما ينتجون".
ويعتبر البازعي أنّ الحاجة إلى مشاريع الترجمة تتلخّص في أسباب عدّة، منها أن الثقافة العربية لا تزال بعيدة من تحقيق الهدف المطلوب في ردم الفجوة بينها وبين ثقافات أخرى تنتج المعرفة والإبداع بكثافة أكبر. وهذا ينسحب على الأدب كما ينسحب على العلوم بجوانبها الثلاثة: الإنساني والعلمي والتقني. ثم يختم قائلاً: "ما تحقق في العقد الأخير مبهج ومبشر، لكنه ينبغي أن يكون أيضاً مشجعاً على المزيد من الدعم لاسيما أن الإقبال على الأعمال المترجمة كبير كما يبدو لي مما يباع في معارض الكتب وغيرها".
- خالد الجبيلي: العرب لا ينصفون المترجم
"الترجمة بمجملها عملية صعبة لا يدرك مشاقها إلاّ من يكابدها. ترجمت أخيراً ثلاث روايات يمكن أن نطلق عليها اسم روايات فلسفية لعالم ومحلل نفساني مرموق اسمه البروفسور إرفين يالوم، وهي: "عندما بكى نيتشه"، و"علاج شوبنهاور"، و"مشكلة سبينوزا". أظن أن هذه الأعمال كانت من أصعب الترجمات التي أنجزتها لأنها كانت تتطلب بحثاً وقراءة متعمقة في أعمال هؤلاء الفلاسفة، إضافة إلى التزام الدقة في المصطلحات. ولكن بشكل عام، أحبّ أن أترجم النصوص التي أرى فيها متعة وفائدة لي وللقارئ".
هذا ما يقوله خالد جبيلي عن أصعب الترجمات التي أنجزها، أمّا عن أشهرها والتي تعود إلى الكاتبة التركية أليف شفق فيقول: "روايات أليف شفق سريعة الوصول والانتشار. وأظن أن المواضيع وتنوعها وربطها بين الماضي والحاضر هي من الأسباب التي جذبت القارئ إلى أعمالها وجعلتها في مصاف الكاتبات العالميات. وأنا سعدت بترجمة أعمالها إلى العربية، خصوصاً أنها تتبوأ مركزاً مهماً لدى القارئ العربي".
وعن سؤال الترجمة عبر لغة وسيطة، يجيب الجبيلي بالقول: "كنت قد ترجمت بعض الأعمال عبر لغة وسيطة بعدما أحسست برغبة في ترجمتها لأنني رأيت أنها تضيف بعداً لغوياً وأدبياً حتى وإن كانت تُرجمت سابقاً. أرى أننا بحاجة أحياناً إلى مثل هذه الترجمات، بخاصة إذا لم يكن هناك مترجمون ينقلون تلك الأعمال من لغتها الأصلية".
وبعد التطرق إلى مسألة الجوائز التي باتت تمنح إلى المترجمين أو يتم توزيعها مناصفة بين الكاتب والمترجم، سألنا خالد الجبيلي ما إذا كان المترجم العربي مازال مظلوماً، فأجاب: "نعم أعتقد أن المترجم لم يُنصف تماماً في العالم العربي ولا يحصل على المكافأة التي يستحقها مع أنه يقوم بعمل شديد الأهمية في إثراء الثقافة ويسهم في نقل الأدب العالمي لاطلاع القارئ العربي على مواضيع لا يتداولها عادة الكتاب العرب. وأرى أنه يسهم أيضاً في إثراء اللغة العربية بمفاهيم وعبارات لغوية جديدة".
وختم الجبيلي بالتعليق على تهمة الخيانة الأدبية التي تلاحق المترجم مراراً قائلاً: "يستحضرني هنا خورخي لويس بورخيس الذي تساءل: أليس عمل المترجم أكثر براعة، وأكثر تحضراً من عمل الكاتب نفسه؟ كما اعتبر الناقد والروائي الفرنسي موريس بلانشو المترجمين "كتّاباً من أندر الأنواع، لا نظير لهم". وإذا كان المقصود من هذا القول الإيطالي المشهور إن المترجم لا يستطيع أن ينقل النص الأصلي إلى لغته بتطابق مطلق، فهذا صحيح لأسباب تتعلق بخاصية كل لغة. أما إذا كان المقصود بأن المترجم يقوم بتحريف أو إضافة أو حذف عبارات لا تروق له بادعاء أن تلك العبارات لا تتناسب مع أفكار ومفاهيم مجتمعه، فإني أعتبر ذلك خيانة عظمى في حق كلّ من الكاتب الأصلي والقارئ الذي ينقل إليه الترجمة. ولا أرى أن لدى المترجم حرية في التصرف بالنص الأصلي أو محاولة تغيير أو قلب بعض المفاهيم أو الآراء الواردة فيه بادعاء أنها لا تروق له أو لمجتمعه. إن حرية المترجم هنا تكمن في أن يمتنع عن ترجمة النص أصلاً لكي لا يخدع القارئ الذي يضع عادة ثقته التامة بالمترجم".
- سمير جريس: الترجمة تكاد تقترب من التسوّل
قبل أن نتطرّق مع المترجم المصري المقيم في ألمانيا سمير جريس إلى فعل الترجمة بذاته، كان بديهياً أن نسأله عن مدى اهتمام القارئ العربي بالأدب الألماني، فأجاب قائلاً: "من الصعب الإجابة عن هذا السؤال من دون تعميم. من واقع تجربتي الشخصية في الترجمة سأقول نعم، هناك اهتمام نسبي بالأدب الألماني، لكنّ الإقبال عليه ليس كبيراً مثل الإقبال على قراءة أدب أميركا اللاتينية، أو الأدب الروسي (الكلاسيكي)، أو الأدب الأميركي والإنجليزي أو الأدب الفرنسي. الأدب الألماني أدب متنوع جداً، يضم اتجاهات ومدراس عديدة. وبعد الحرب العالمية الثانية ساد تيار كان شديد الانشغال بقضايا ألمانيّة بحتة، قضايا مواجهة الماضي النازي والبحث عن المسؤولية عما حدث. هذه الفترة أنتجت أعمالاً تهتم بالمضمون والقضايا التي تعالجها، أكثر من اهتمامها بتقديم "قصة" بالمعنى الشائع أو"حدوتة" شيقة، وهو ما جلب للأدب الألماني سمعة عالمية سيئة، بأنه "أدب ذهني"، أي أدب صعب، أو مملّ في بعض الأحيان. هذا الحكم النمطي تؤكده بالطبع بعض الأعمال. في المقابل هناك أسماء أصبحت على قائمة أفضل المبيعات في العالم، مثل أعمال باتريك زوسكيند صاحب "العطر". وكما قلت، الأدب الألماني، لا سيما في العقود الأخيرة، أصبح شديد التنوع. وعموماً، أرى أن صدور طبعة ثانية من الترجمات التي أنجزتها بمثابة دليل على اهتمام القارئ العربي بالأدب الألماني، ومنها على سبيل المثل ترجمة رواية "قاتل لمدة عام" لدليوس، و"حرقة القتل" لنوربرت غشتراين، و"الوعد" لدورنمات، و"صداقة" لتوماس برنهارد".
وعن فضول القارئ الألماني تجاه الأدب العربي، قال جريس: "هناك اهتمام محدود وموسمي بالأدب العربي. مثلاً، عندما حلّ العالم العربي ضيفاً على معرض فرانكفورت للكتاب في عام 2004 نشطت حركة الترجمة إلى الألمانية. كما أن الظروف السياسية تسهم في ترجمة بعض الأعمال. ثمّة اهتمام نسبي بأدب دول "الربيع العربي"، لا سميا الأدب السوري بعد وفود مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى ألمانيا. وفي سياق آخر، يرى جريس أنّ نسبة الترجمة من الألمانية إلى العربية ليست كافية أبداً، بحيث لا يترجم من الألمانية إلاّ القليل جداً، وحتى هذا القليل يصدر غالباً بناء على مبادرات دعم من جهات ألمانية مثل مشروع "ليتريكس" أو برامج الدعم من معهد غوته الألماني أو مؤسسة بروهلفتسيا السويسرية. ومن دون برامج الدعم تلك سيكون عدد الكتب المترجمة من الألمانية قليلاً جداً، أقل بكثير من الآن.
وردّاً على سؤالنا حول ما إذا كانت الترجمة في عالمنا العربي مازالت مهنة مجحفة، أجاب جريس بلا تردد: "بالطبع نعم. إذا استثنينا بعض المؤسسات الكبرى التي تدعم الترجمة، فإن الترجمة كمهنة تكاد تقترب من التسوّل. الناشر يقول إن الكتاب مكلف، ويقرصن بسرعة، كما أن عدد القراء العرب في تناقص، لذلك يحاول تخفيض التكاليف، ومنها طبعاً تكاليف الترجمة. والنتيجة تراها في ترجمات تحتاج إلى ترجمات أخرى لكي يفهمها القارئ".
- صالح علماني: تغيّرات مادية ومعنوية
يعتقد المترجم صالح علماني أنّ الترجمة طرأت عليها بعض التحولات خلال العقد الأخير، فيقول: "لقد طاولت التغيرات في السنوات العشر الماضية الكثير من مناحي حياتنا العامة والمهنية، فتبدلت معايير وتقاليد اجتماعية واقتصادية وفكرية كثيرة، ولم تتخلف مهنة الترجمة، ولا سيما الترجمة الأدبية، عن مواكبة هذه المتغيرات. فلم تعد دوافع المترجم ورغباته هي التي تحدد خياراته، بل صار هناك من يختار له. فالناشر هو من يختار الكتب، ويشتري حقوق ترجمتها، ويعرضها على المترجم. أي أن المترجم صار مرتبطاً بالناشر الذي يكلفه بالترجمة، وصارت خيارات المترجم محددة في خيارين اثنين، إما أن يقبل العرض المقدم إليه أو يرفضه. لقد ولى الزمن الذي كان المترجم يختار كتاباً أحبه ويعكف على ترجمته بشغف ومحبة. أما من الناحية المادية، فقد حدثت تحولات كبيرة نحو الأفضل، مع العلم أن سوق الكتاب مازال محدوداً في عالمنا العربي. صحيح أن هناك بعض الكتب التي تحقق مبيعات عالية نسبياً، ولكن ليس بالمقدار المرغوب".
ويختم علماني بالحديث عن الجوائز وأهميتها في مسار المترجم العربي، فيقول: "مسألة الجوائز مهمة جداً، ولكنها تبقى محدودة على الرغم من توسعها في السنوات القليلة الماضية، بحيث لا يستفيد منها سوى قلة محدودة جداً من المترجمين. ومن جهة أخرى، توافرت للمترجمين ميزات معنوية وقانونية كبيرة. فقد صار المترجم وفقاً لقوانين الملكية الفكرية هو "مؤلف الترجمة" وله ميزات المؤلف نفسها، ولديه حقوق يعاقب عليها القانون إن تمّ التعدي عليها. وحقوق الترجمة مادياً تستمر لورثته مدة سبعين عاماً بعد وفاته، بينما تستمرّ ملكيته الأدبية لترجمته إلى أبد الآبدين. كما أن عقود البيع القطعي للترجمات صارت غير شرعية قانونياً، بل هي جنحة يعاقب عليها القانون".
- ماري طوق: الترجمة مستقبل النصّ
ترجمت ماري طوق نحو أربعين كتاباً من اللغة الفرنسية، وأصبحت اليوم من بين أبرز المترجمين، ومع ذلك فإنها لم تختر فعل الترجمة، بل هو الذي اختارها، كما تقول. "بدأتُ صدفة، ولم أكن أعرف حينذاك أنني سأستمرّ في هذا العمل. قبل أن أغوص في هذا العالم، لم أكن أعرف ما يتطلبه من انتباه فائقٍ، وثقافة مستديمة، وتمرّس يوميّ، عدا التمكّن اللغوي. والأهمّ هو الالتزام بالمسؤوليّة الأخلاقيّة والثقافيّة التي ينبغي أن يتحلّى بها المترجم تجاه الكتاب الذي يشتغل عليه. وبعدما كانت الترجمة مرتبطة بحالة مزاجية، أصبحت التزاماً بمهنةٍ لها عدّتها التقنيّة الكاملة من قواميس متخصّصة ووسائل رقميّة هائلة، وبمهلة زمنيّةٍ محدّدة ضمن عقد بين المترجم والناشر". وعمّا إذا كانت ترى إلى الترجمة كفعل مجحف، تقول طوق: "الترجمة بلا شكّ عمل محبط لكونه يجعلك تشعر دائماً بأنّك مجرّد وسيط بين الكاتب والقرّاء. ولكن على الرغم من هذا الشعور الدائم بالإحباط، ثمّة متعة كبيرة في اكتشاف نصّ جديد تُقدّمه إلى القارئ العربي ليتعرّف إلى مبدعين جدد بروحك وأسلوبك. من دون أن ننسى أنّ الترجمة تنتشلك من ذاتك وعزلتك لتضعك في عالم آخر، صاخب، يبعث فيك شيئاً من الخوف وكثيراً من التحدّي. ومن الناحية المادية، يبقى مجهود المترجم أكبر بكثير مما يتقاضاه". وترى طوق أنّ المترجم يستحق مزيداً من التقدير مقابل دوره المهم في ترسيخ قيم التواصل والتفاعل والانفتاح على نتاج الفكر الآخر.
ماري طوق تؤمن أن الترجمة تسهم في ترسيخ التواصل وإثراء المعرفة، وتعترف بحقّ المترجم في أن يخرج من أفقية المعنى لأنّ "النص، كنا يقول ديريدا، يبقى مفتوحاً جرّاء قراءاته وترجماته المتعددة. فالترجمة هي مستقبل النصّ وهي التي تمنحه إمكان النموّ في لغة أخرى وأن يعيش حياة أطول وأجود متجاوزاً إمكانات المؤلف نفسه".
- معاوية عبد المجيد: أدبنا خسر أصالته
اختار المترجم السوري الشاب معاوية عبد المجيد أن ينوّع بين الأدباء والثيمات الأدبيّة، لأنّه لا يحبّ جدولة المترجمين ووضعهم في خانات. ومع ذلك لا يزعجه أن يُسمّى بـ "مترجم إيلينا فيرانتي"، لا سيما أنها رواية أتعبته كثيراً في الترجمة وأعطاها كل جهده وطاقته.
وعن الأسس التي يرتكز عليها في ترجمة أي نص، أجاب قائلاً: "هناك أسس كثيرة، مثل أهميّة الكتاب أو أهميّة الموضوع الذي يتناوله. ولكن يتوقّف كلّ شيء عندي على براعة الكاتب في معالجة الإشكاليّة التي يطرحها".
وعن رأيه في تجربة الترجمة عبر لغة وسيطة، يقول: "أنا تخصّصت في مجال الترجمة الأدبية المقارنة، وبتّ أرى أنّه ينبغي على المترجم، إن استطاع، أن يطلع على الترجمات الأخرى للكتاب الذي يريد ترجمته. ففي تلك الترجمات قد يجد حلولًا لمشاكل وعوائق قد تواجهه. وكان كذلك إذ ترجمت "مقبرة الكتب المنسية" لكارلوس زافون من الإسبانية بالاعتماد على الترجمة الإيطالية والاطلاع على تلك الفرنسية. عمل شاقّ، لكنّ نتائجه مثمرة".
وبما أنه حاصل على جائزتين خلال فترة قصيرة من مسيرته كمترجم، كان لا بدّ من سؤاله عن الجوائز ودورها في تقدير المترجم، فأجاب قائلاً: "المترجم العربيّ مظلوم من الناحية المادية، لكنّ وضعه المعنوي أفضل بكثير من المترجمين في اللغات الأخرى. ينتقصون من قدْره حيناً، يتعمّدون تجاهله أحياناً، لكنّ القارئ العربيّ لا يستطيع أن ينسى أسماء مثل سامي الدروبي وصالح علماني وغيرهما. سيبقى المترجم العربيّ مظلوماً حتى لو نال جائزة كلّ عام. ذلك لأنّ الجهد المبذول لا يضاهيه أجر. وآمل في أن نعمل كلّنا معاً على تكريس هذه الجوائز بما يضمن استمرارها واتساعها لتشمل كلّ المترجمين الأكفّاء".
ولدى سؤاله عن الاهتمام الضيئل بأدبنا العربي مقابل ترجماتنا الوافرة لأدب الغرب، أجاب عبد المجيد بالقول: "ما دمنا قرّرنا في لحظة ما أن يكون أدبنا ما هو إلّا تعريب لأدب الغرب، فإنّ الغرب لن يجد ضرورة لترجمة هذا الأدب إلى لغاته. يبدو لي أنّنا فقدنا الأصالة، من دون أن نعتمد الحداثة تماماً. وبات همّنا الوحيد أن نجيب عن تساؤلات الأمم الأخرى عنّا وعن طبيعة مجتمعاتنا وتطلّعاتنا وديننا وثقافتنا. لا أنكر أنّ لدى الغرب أهواء انتقائيّة، وإذا كانت المكتبة الإيطاليّة تفتقر إلى كتب عربيّة، فإنّ المكتبة العربيّة لا تحتوي على أكثر من عشرة في المئة ممّا أنتجته إيطاليا، في الأدب على الأقلّ".